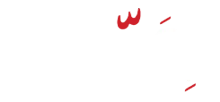الصرف التعسفي في لبنان بين القانون والواقع
خاص بِكَفّيكم: الصرف التعسفي في الواقع العملي اللبناني: بين قانون يحمي العامل ونصوص بلا تنفيذ
كتب علي اياد خشمان؛ في بلد يتهاوى فيه الإقتصاد وتتساقط معه فرص العمل، بات الصرف من الخدمة مشهدًا يوميًّا مألوفًا يختصر وجع العامل اللبناني بين ورقة التبليغ وصمت القانون. فبين أرباب عمل يبررون قراراتهم بحجّة الظروف القاهرة… وعمالٍ يجدون أنفسهم خارج أسوار العمل بلا إنذار ولا تعويض، تضيع العدالة في دهاليز الأزمة.
ورغم أن القانون اللبناني رسم بوضوح حدود الصرف المشروع ومنع التعسف باستعمال الحق… إلا أنّ الواقع يبيّن أن النصوص تبقى عاجزة أمام ممارسات تفرغها من مضمونها.
فهل تحول القانون إلى شاهدٍ صامت على انتهاك حقوق الأجراء؟ أم أن الحماية لا زالت ممكنة في دولة تتقدم فيها المصالح على المبادئ؟ وأين تقف الحدود بين حماية العامل ومراعاة أصحاب العمل؟
الصرف التعسفي: قانون العمل والنصوص الصريحة
يُحدّد قانون العمل اللبناني الصادر في 23 أيلول 1946 بشكل عام، والمادة 50 منه بشكل خاص، حدود الصرف من الخدمة. فقد أشارت المادة إلى حرية صاحب العمل في صرف الأجير في عقود العمل غير محددة المدّة، وفي أيّ حينٍ يشاء. إلّا أنّها، في المقابل، قيّدت هذا الصرف بوجوب حسن استعمال الحق، مشيرةً إلى حالة الإساءة في استعماله وتجاوز حدود النص.
وقد أضافت المادة 50 الحالات التي يمكن تصنيفها من قبيل تجاوز الحق أو إساءة استعماله، حيث ذكرت في الفقرة (د) أنّه في حال الصرف لسبب غير مقبول أو لا يرتبط بأهلية العامل أو تصرّفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارتها وسير العمل فيها، يُعدّ هذا الصرف مخالفًا للقانون. كما أضافت المادة حالات أخرى، منها انتساب العامل أو عدم انتسابه إلى نقابة مهنية معينة، أو قيامه بنشاط نقابي مشروع ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية الإجراء أو بموجب اتفاق عمل جماعي، وكذلك تقدّمه للانتخابات النقابية أو انتخابه عضوًا في مكتب نقابة أو تولّيه مهمة ممثل للعمال في المؤسسة.
وتوسّعت المادة أيضًا لتشمل تقديم العامل، بحسن نيّة، شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل والنصوص الصادرة بمقتضاه، كما تشمل إقامته دعوى على صاحب العمل تبعًا لذلك، إضافةً إلى ممارسته حرياته الشخصية والعامة ضمن نطاق القوانين المرعية الإجراء.
وفي جميع هذه الحالات، اعتبر القانون أن الصرف هذا يكون تعسفيًا. ويمكن القول إنّ كلّ حالة على حِدة تحتاج إلى تفسيرٍ عميقٍ لمصلحة العامل مع مراعاة حقوق صاحب العمل. فعندما أشار القانون إلى حق العامل في منع صرفه إلا إذا كان الصرف مبررًا قانونًا، واعتبر الصرف تعسفيًا في حال تقديمه شكوى ضد صاحب العمل، أحاط هذا الحق بمبدأ حسن النيّة، بحيث لا يجوز أن تكون الشكوى كيديّة أو افترائية أو تهدف إلى الإضرار بصاحب العمل.
حقوق العامل مقابل الصرف التعسفي
بالمقابل، لا يمكن الاكتفاء بنصوص اعتبارية تميّز بين الصرف التعسّفي والصرف المشروع! بل لا بدّ من وجود آلية ردع فعّالة تُلزم صاحب العمل باحترام الضوابط القانونية، وتمنع التلاعب بحقوق الأجراء أو المساس باستقرارهم المهني. فالمشرّع لم يتوقف عند وصف الفعل بأنه تعسّفي… بل حرص على إقرار جزاءٍ يكرّس الحماية الفعلية للعامل، ويشكّل في الوقت نفسه رادعًا لصاحب العمل عن إساءة استعمال حقه في الصرف.
وفي هذا الإطار، نصّت الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون العمل اللبناني على أنّه يحقّ للعامل المتضرّر من الصرف التعسّفي أن يطالب بتعويض عادل، يُقدَّر على أساس نوع العمل، وسنّ العامل، ومدّة خدمته في المؤسسة، ووضعه الصحي والعائلي، ومدى الضرر اللاحق به نتيجة الصرف. وقد حرص المشرّع على تحديد حدود هذا التعويض… بحيث لا يقلّ عن أجر شهرين ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرًا… وذلك بالإضافة إلى التعويضات الأخرى المقرّرة في القانون، كتعويض بدل الإنذار وغيره من الحقوق المستحقّة.
وبذلك، يتبيّن أنّ التعويض لم يُقرّ كمجرد تدبيرٍ مالي، بل كأداة عدالة اجتماعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين سلطة صاحب العمل في إدارة مؤسسته وحقّ الأجير في الأمان الوظيفي، ضمانًا لاستمرارية علاقة العمل في إطارٍ من الاحترام المتبادل والعدالة القانونية.
الواقع المختلف، تعسّف تقابله عدالة بطيئة
لكن الواقع اللبناني منذ العام 2019، تغيّر لِمنحى آخر، حيث لجأت العديد من المؤسسات الى تسريح عدد كبير من العاملين بحجة الأزمة الإقتصادية وغالبًا ما تُستخدم هذه العبارة لتغطية مخالفات واضحة في القانون، بالاضافة إلى تغييب حقوق العامل. فعلى الرغم من إتاحة القانون لصاحب العمل التخفيف من عدد العمال، مما يقلّص حجم المؤسسة، إلا أنه ربطها بعوامل أخرى كتبليغ وزارة العمل مسبقًا بالصرف مع وضع جدول ينظم هذا الفسخ للعقود والتعويضات الناشئة عنه. فلا يبقى للعامل سوى أن يقبل بهذا الواقع أو أن يدخل في صراع طويل أمام مجلس العمل التحكيمي لسنوات.
ويُعتَبر مجلس العمل التحكيمي المرجع القضائي المختصّ بالفصل في نزاعات العمل الفرديّة. وقد أُنشئ أساسًا ليؤمّن آلية قضائية متخصّصة تضمن سرعة البتّ في القضايا العمالية وعدالتها. غير أنّ الواقع العملي يكشف عن تحدّيات بنيويّة جدّية تعيق قيام المجلس بدوره بالشكل المنشود. فقد بات يعاني من ضعف في البنية التحتية القضائية نتيجة النقص في عدد القضاة، إلى جانب تكدّس كبير في الملفات وتأخّرٍ ملحوظ في إصدار الأحكام.
وغالبًا ما يجد الأجير نفسه ينتظر سنوات طويلة قبل صدور الحكم الذي يُنصفه، ليصطدم بعد ذلك بصعوبات إضافية في مرحلة التنفيذ… خصوصًا في ظلّ تعنّت بعض أصحاب العمل وغياب فعالية الإجراءات التنفيذية. وهكذا، فإنّ ما أراده المشرّع من آلية سريعة وعادلة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ميدان العمل، تحوّل في الممارسة إلى مسارٍ طويلٍ مرهقٍ للعامل وضعيف الجدوى العملية… الأمر الذي يُضعف الثقة بمبدأ حماية الأجير الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية لقانون العمل اللبناني.
وهكذا تتحول العدالة البطيئة الى ظلم مقنّع ويضيع جوهر الحماية التى وعد بها المشرّع.
مُعضلة العمل عن بعد
قبل صدور التعديل التشريعي في 24 نيسان 2025، كان العامل عن بُعد يعاني من فراغٍ قانونيٍ واضح في الحماية من الصرف التعسّفي. فالقانون اللبناني الصادر عام 1946 لم يتناول العمل عن بُعد أو أي شكل من أشكال العمل غير التقليدي… إذ بُني على نموذج العلاقة الكلاسيكية بين الأجير وصاحب العمل داخل المؤسسة. ونتيجة لذلك، كان العامل الذي يؤدي مهامه من خارج مقر العمل غير مشمولٍ صراحةً بأحكام المادة 50 من قانون العمل… التي تنظّم الصرف التعسّفي وتضمن التعويض عند وقوعه.
هذا النقص التشريعي جعل العامل عن بُعد في موقع هشّ، إذ يصعب عليه إثبات العلاقة التعاقدية المستمرة… أو إثبات ساعات العمل الفعلية، أو حتى إثبات واقعة الصرف نفسها في غياب رقابة مباشرة أو سجلات مادية. كما كان صاحب العمل يتمتّع بمرونة مفرطة في إنهاء العقد دون مبرّرٍ واضح! متذرّعًا غالبًا بطبيعة العمل أو بانقطاع التواصل التقني أو بتراجع الإنتاجية. وبهذا، افتقد العامل عن بُعد إلى الحدّ الأدنى من الأمان الذي يتمتّع به العامل التقليدي. إذ لم يكن يملك الوسائل القانونية الكافية للمطالبة بتعويض الصرف التعسّفي أو لإثبات سوء نية صاحب العمل في إنهاء العلاقة.
من هنا، برزت الحاجة الملحّة إلى تعديل قانون العمل اللبناني لإدخال العمل عن بُعد ضمن نطاق الحماية القانونية… وتكريس مبدأ المساواة في الضمانات الأساسية. خصوصًا في ما يتعلّق بحق الأجير في الأمان من الصرف التعسّفي والتعويض العادل عند حصوله.
من المسؤول: الصرف التعسفي في لبنان بين القانون والواقع في التطبيق
تتجلّى المسؤولية المزدوجة لتُلقي بظلالها على فعالية الحماية العمالية في لبنان. فمن السهل أن يُقال أنّ الأزمة الاقتصادية تبرّر الصرف من الخدمة، لكن من الصعب إيجاد توازن عادل بين مصلحة صاحب العمل في الاستمرار الاقتصادي وحقّ الأجير في الاستقرار المهني والمعيشي. فالقانون، وإن كان حاضرًا بنصوصه، يبقى بحاجة إلى رقابة فعليّة تضمن حسن تطبيقه من قبل وزارة العمل ومجلس العمل التحكيمي.
ولا يمكن تحقيق هذه الغاية دون تفعيل الدور النقابي… الذي يُعدّ ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق العمال وممارسة الضغط المشروع لتطبيق القوانين بعدالة. كما تبرز ضرورة تسريع آليات التقاضي في النزاعات العمالية… إذ إنّ بطء الإجراءات القضائية يُفرغ النصوص من مضمونها ويجعل حماية الأجير شكلية أكثر منها واقعية. وهكذا، فإنّ الإشكالية لا تكمن في غياب القوانين بل في ضعف تطبيقها… وفي غياب منظومة رقابية متكاملة توازن بين استمرارية العمل وكرامة العامل.
في الختام، يمكن القول إن قانون العمل يبقى مجرد إعلان نوايا، والعامل اللبناني الحلقة الأضعف في معادلة لا ترحم. فالصرف التعسفي ليس مسألة قانونية فحسب، بل قضية إنسانية تمس كرامة وحق المواطن في العيش بأمان اجتماعي مهني. وإلى حين تحول النصوص الى تطبيق فعلي ومحاسبة حقيقية، يبقى السؤال المطروح، هل يحمي القانون العامل في لبنان أم يكتفي بمواساته؟